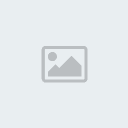
أما قبل هل الصراع بين الإسلام والغرب يعود إلى أن الخطاب الديني الإسلامي قرآن وحديث مفروض على عقول الناس بالتربية ويدعو إلى التسليم بدون برهان؟ وإذا كان يدعو إلى رفض كل ما لا يثبته البرهان فكيف تنسجم الدّعوى التي يحملها هذا التساؤل مع حقيقة أنّ الإسلام جاء إلى الناس كافة؟ ممّا يفترض أنّ الخطاب القرآني والاقتصار عليه في التعامل كان سبباً في انحباس الفكر الإسلامي، وفي الصّراع الدّائر بين الإسلام والغرب والناتج حبسهم عن أنّ الفكر الإسلامي ذاته لا ترقى أدلته إلى مستوى البراهين الكفيلة بإحداث التفاعل الإيجابي بين المتحاورين وتشكيل تواصل واع قائم على سلامة الممارسة المنطقية للفكر والثقافة.
لقد رافق هذه الدّعوى دعوى أخرى ليست أقل خطورة من الأولى وهي أنَّ أساليب الحوار بدأت مع ظهور الفرق الكلامية، وأنّ الفلاسفة المسلمين هم فقط الذين مارسوا النظر العقلي ممّا يوقفنا عند محاولة فصل الفلسفة الإسلامية عن الخطاب القرآني وإرجاعها إلى أصول يونانية، فإذا ما أراد المسلمون التواصل مع الغرب بالقرآن وقعوا في الصراع، الأمر الذي يدعو إلى اتّهام الخطاب بخلوّه من أي تصوّر منطقي يفرز الشروط الأساسية للتحاور من استدلال وتعليل فرضتهما الفعالية العقلانية الإسلامية التي ليست بالضرورة هي نفسها العقلانية الغربية؛ لأن في ذلك إلغاء للتفرّد والخصوصية واختلاف الزمان والمكان، مع أنّ ذلك لا يعني أن يتناقضا، لأن التناقض هو الفيصل بين العقلانية وعدمها وخاصة أنّه كثيراً ما يوضع الدين في عرف البعض مقابلاً للاعقلانية وكأنّ الحدود بين النظر العقلي والدين حدود فاصلة. والحق أنّ ما غاب عن جلّ الباحثين والمنظرين قديماً وحديثاً، هو أنّ كثيراً ممّا يعتبر مكوّناً ذاتياً للنظر العقلي يتبيّن عند إمعان النظر فيه أنّه مستمدّ من معان دينية صريحة(2).
قد تنطبق هذه الدّعوى وغيرها على الدّيانة الغربية والتي لا تحتوي نصوصها على قوانين الاشتغال العقلي، الأمر الذي وسم الخطابات الدينية الغربية بقاعدة "آمن كي تعقل" أمّا الأمر مع الخطاب القرآني فمختلف، لأنّه اعتمد على الحجة العقلية ووُجّه للقوم الذين يعقلون ويمارسون قاعدة "اعقل لكي تؤمن" مقابل "آمن لكي تعقل" فإذا ما تجسّد اشتغال العقل في الخطاب نكون أمام فعالية خطابية تتوفّر بالفعل وبالضرورة على أُسس التحاور الاستدلالية بمختلفة صورها التي ورد بها النص القرآني، والتي لا نستطيع أن نحصيها في أشكال وصور معيّنة لعلّ أهمها الصّور الحجاجية باعتبارها الصنف الأكثر قابلية للإمساك به، ويمكن التعامل به في مختلف مجالات التّثاقف العامة التي تيسّر التواصل الإنساني، كما يؤدي إلى الإقناع الذي يفرض المشاركة بين الطرفين المتحاورين دون إكراه، وقد تطال اعتقاد المقتنع فيلتزم بما يعتقد به مُحاوره إذا اقتنع برأيه واعتقد بصحة الدليل القائم عليه هذا الرأي.
غير أنّ موضوع الإقناع وإن كان هو فعل الصّورة الحجاجية، فإن الخطاب القرآني حقّق هذا الفعل بواسطة قوى أفعال الكلام المنجزة من خلال العبارات وما تحقّقه بدورها من آثار ونتائج مهما كانت صفتها، فإن إيقاعها يبقى إقناع الآخر، ليس من باب إحداث الغلبة لطرف على حساب الآخر ولكن من أجل الحوار والتواصل.
لا شكّ أنّ موضوع الآخر باستناده إلى أُسس الذاتية وإلى صيغة العلاقات ما بين الشخصية يتّخذ حساسية معينة وخاصة في الموضوعات المرتبطة بالعقيدة، غير أنّه وفي صميم الخطاب العقائدي يمكن أن نتعرّف على الإشكاليات نفسها التي طرحت عند فلاسفة اللُّغة والحوار، وأهمّها إشكالية وجود الآخر ومعرفة الآخر؛ فالخطاب القرآني يحيلنا إليها من خلال الحوار المعرفي الذي يحدّد نظرة الإسلام إلى الخلاف الفكري بأنّه مقولة تفتح كل مجالات التحاور والتواصل لا الصّراع والعداء، وأنّ هذا الدّور هو جوهر حركة الفكر والإنسان في هذا الوجود، وأن نتحاور معناه أن نضع حدّاً للمواجهة؛ لأنّ الله أراد من الإنسان المسلم أن يفكّر من أجل أن تنفتح عقول الآخرين على دين الفطرة، وجاء الإسلام من خلال القرآن ليكون دين الحوار الذي يطلق للفكر أن يفكر ويحاور الآخرين على أساس الحجّة والبرهان، ولقد استطاع المسلمون أن ينفتحوا على العالم من خلال ممارسة قواعد الحوار التي علمهم إيّاها القرآن والمتمثّلة في طريقة المناظرة "ومعلوم أن هذه الطريقة التي شملت جميع دوائر المعرفة الإسلامية العربية تتبنى وظائف منطقية تأخذ بمبدأ الاشتراك مع الغير في طلب العلم وطلب العمل بالمعلوم، كما تنبني على قواعد أخلاقية تأخذ بمبدأ النفع المتعدّي إلى الغير أو إلى الآجل"(3).
ولمّا بعد المسلمون عن القرآن افتتنوا بالحضارة الأوربية التي صوّرت الإسلام ومن منطلق الصراع معه بصورة التّطاحن والعنف وجعلت منه دليلاً على أنّ الإسلام يرسّخ الحلّ الأوحد والنظرة الأحادية والإقصائية، وتأثر المسلمون أنفسهم بهذه الصورة فابتعدوا عن القرآن وجاء الكفر في ثوب الاستعمار ليجمّد القرآن في نفوسنا وحياتنا، وليوحي إلينا بأنّ طريق الخلاص يتمثّل فيما استحدثه من مبادئ وفيما أثاره من فلسفات، ووجدت هذه المبادئ والفلسفات مجالها الرّحب في أفكار الجيل وتطلعاته من خلال الإطار الفكري الذي صنعته أساليب التربية الغربية وغذته مفاهيمها الحضارية ووجهت القوى المادية التي يمتلكها الاستعمار. ولقد استطاعت كل تلك العوامل أن تثير في شخصيته الشعور بضعف الأصالة الفكرية المرتبطة بجذور العقيدة والتاريخ وتخلق في داخله "عقدة الاستغراب" باعتبارها الطريق الوحيد للدخول إلى أجواء العصر والارتفاع إلى مستواه حتى أغلق على نفسه باب الحوار(4).
وحين نفكر اليوم كيف السبيل إلى تحويل الافتتان والشك في عقيدتنا، لا بدّ أن نفكر أوّلاً في تعريف هذا الجيل برسالة الإسلام التي قامت على الحوار، ولا يتسنّى لنا ذلك إلاَّ من خلال الوقوف على الاستراتيجية القرآنية في الحوار وكيف تجسّدت من خلال سنّة رسوله باعتبارها الوجه العملي لما ورد في القرآن، ولذلك تبدو العودة إلى القرآن ملحّة كلّما عادت مسألة الحوار في المؤتمرات والندوات العالمية إلى الطرح والنّقاش.
إذا كان الإسلام قد جاء لا لكي ينضاف إلى الديانات السابقة بل لتصحيحها بعد الانحراف في العقيدة، فإن الخطاب الذي يحمل هذا التصحيح كان لا بدّ أن يجسّد أساليب التخلّي عن صور الانحراف والتحلّي بأساليب الفطرة من عقل وحقّ، والمحاجة بما لا يناقض الحواس والعقل الفطري الذي يميّز بين المفاهيم والأشياء "ويدرك أن الأشياء تتمايز في الأذهان كما تتمايز في الأعيان ولا يمكن للشيء الواحد أن تكون له من الجهة الواحدة أكثر من حقيقة واحدة"(5).
إنَّنا في هذه المداخلة نحاول أن نتجاوز الدراسات التي أُقيمت للكشف عن أساليب الحوار وقواعده ومعطياته على غرار ما فعل محمد حسين فضل الله في كتابه "الحوار في القرآن" برغم أهمية الدراسة في تصنيف بعض النصوص من حيث طبيعة المخاطبين ووضعية الخطاب، غير أنّنا نركّز على العبارة القرآنية من حيث هي فعالية خطابية نعيد بفضلها تنظيم منطق الخطاب القرآني على ضوء الدّراسات الحديثة كالتداولية Pragmatique، والغرض من هذا هو المساهمة في بناء منهج علمي يسهم بدوره في المناخ الفكري الذي يسعى إلى التفكير في فلسفة اللّغة في ضوء اللسانيات والمنطق. وكان الغرب قد توصّل بفضلها إلى نتائج بالغة الأهمية بصدد أثر اللّغة في الثقافة، وأنّ بنية اللُّغة والفكر أمر واحد ومن ثمّ "فاللّغة ليست أداة أو وسيلة للتخاطب والتفاهم والتواصل فحسب، وإنّما اللُّغة وسيلتنا للتأثير في العالم وتغيير السُّلوك الإنساني من خلال مواقف"(6).
وسوف يمكّننا هذا من ردّ الدعوى القائلة: إن الخطاب القرآني يصف حالة شيء ما أو يثبّت واقعة، وفي الحالتين فهو كلّه يفيد فائدة خبرية أو ينتج أحكاماً ممّا يفترض فرضها على العقول ونفي التعارض، ولقد اتّضح الآن وفي ضوء المناهج المعاصرة أنّ ما كان يعتقد من العبارات بأنّها أحكام مثبتة إنما يثير إمكانية التفكير فيها بإعطاء النقيض الذي يحمل العقل على المقارنة، وإنّ ما بدا بأنه أحكام قيمة أخلاقية يقصد بها إظهار الشعور العاطفي أو إلزام نوع من السّلوك إنّما يحمل في طيّاته ملابسات الحكم الأخلاقي الذي تنطوي عليه، ومراعاة مقامات المخاطبين بحسب فُهومِهم وعقولهم من أجل إقناعهم، فكثير من العبارات تتوسّل الإقناع في صيغ مقنّعة لا تسفر عن حقائقها إلاَّ بإدراك العلاقات فيما بينها، أو ممارسة آليات في الفهم والتلقي، وبما أنّنا لا نستطيع أن نحصر أنماط هذه العبارات، فسنكتفي فقط ببعض الصور المنطقية لأنواع الأدلّة والحجج التي استعملها القرآن دون أن نتوهّم القدرة على حصر كل هذه الحجج بالعدد، لأنها كثيرة بل بالصوّر الممثّلة فقط، وذلك من أجل إثبات أنّ هناك منطقاً فطرياً لدى جميع الناس صيغت به العبارات القرآنية والحجج التي تحملها، وذلك لدى سليمي الفطرة في جميع الأزمنة والأمكنة ما عدا أصحاب العقول الفاسدة. ولا عجب في ذلك ما دام القرآن اعتبر العقل القوة القادرة والصالحة للحكم على الأشياء والميزان الذي توزن به القضايا وفسادها. وكان لا بدّ لهذا الخطاب الذي يحترم العقل أن يصاغ صياغة يقتضيها العقل حتّى ليصحّ لنا أن نقول: إنّ الخطاب القرآني هو عقل من خارج، لذلك أكد الله في أكثر من موضع دور الحجة في الإقناع وبطرق مختلفة، أي بحسب قدرات الناس العقلية والعاطفية، فمنهم من يقنع بالفكرة عن طريق استهواء العاطفة وإيقاظ الشعور فيهتدي إلى المعرفة وإلى الحكم عن طريق تأمّل باطني في الحجج، ومنهم من لا يذعن لغير البرهان المباشر ويستخدم الاستدلال المنطقي كالقياس والتّمثيل والاستقراء، ومنهم من يقنع كما يقول سيد قطب " بعالم حيّ منتزع من عالم الأحياء لا ألوان مجرّدة وخطوط تصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات بالمشاعر والوجدانيات، فالمعاني ترتسم وهي تتفاعل في نفوس آدمية حيّة، أو في مشاهد من الطبيعة تخلع على الحياة(7).
ولا يعني هذا خُلوَّها من قوة الإقناع، بل هي طريقة أخرى في الاستدلال تدعو إلى النظر وإعمال العقل، لأنّ القرآن كلام موجّه للجميع تفهمه العامة بما هو عليه كما تفهمه الخاصة بما تتوصّل إليه من العمق في الفهم لأنّ "طباع الناس متفاضلة في التصديق، فمنهم من يصدّق بالبرهان ومنهم من يصدّق بالأقاويل الخطابية كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية"(8). كما يذهب الزّركشي الذي اصطنع البرهان للتعريف بعلوم القرآن إلى أنّ القرآن قد اشتمل على جميع أنواع البراهين والأدلة والحجج وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية والسّمعية إلاَّ وكتاب الله قد نطق به(9).
وإذا كانت الحجة هي القضية أو النسق من القضايا التي تقدّم لصحة قضية أخرى، أي مقدمة البرهان التي تعرف أيضاً بأساس البرهان، فقد أكّد القرآن الكريم عليها في أكثر من موضع وبمعانٍ مختلفة، أرقاها الحجة البالغة التي أقامها على العباد في قضية الإيمان والكفر في قوله تعالى: (قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين( ودعا المؤمنين إلى ضرورة التصدّي بالحجة وتحصيل الإقناع المرتكز على البرهان والأدلّة التي لا تناقض العقل، فيكون بها الظّفر عند الخصومة والنزاع، مثلما يكون بها التواصل عند التحاور والجدال بهدف الوصول إلى الحقّ، حتى إن الحوار والجدل ذاته يصبح حقَّاً طبيعياً أمام الله الذي يعلم كل شيء كما في قوله تعالى: (يوم تأتي كلّ نفس تجادل عن نفسها وتوفّى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون( النحل 111.
إنّ القرآن الكريم منهج المسلم في الحياة أراد الله أن يجعل منه منهجاً لإحداث التواصل والتحاور، لذلك جعله في صيغته اللّغوية خطاباً منطقياً من حيث هو معان متلقّاة في لغة يفهمها البشر هي اللُّغة العربية "من حيث هي واردة في مبان يدرك منها الناس المعاني المراد تبليغهم إياها، لكن بحسب اصطلاحهم على تأدية المعاني التي يمكنهم أن يدركوها بواسطة المباني التي تتّخذها الطبيعة البشرية طريقاً للوصول إلى هذه المعاني أو إلى تبليغها"(10). ولذلك فإنّ الصور المنطقية التي استعملها هذا الخطاب ليست واردة فيه بحسب مدارك النبي( فتكون هذه الصور متطابقة تماماً مع هذه المدارك كما قد يعتقد البعض، بل إنّ الصور المنطقية التي استعملها القرآن في صور يستعملها عامة الناس من حيث هم بشر ذوو طبيعة معاصرة لماهية مصدر الخطاب(11).
إنّنا في هذه المداخلة لا نتطرّق إلى قضية أنّ القرآن كلام الله وكيف جارى كلام العرب، فهي مسألة خاض فيها علماء الكلام لأن الذي يتّصل بمطلبنا هو البناء، وإذا بقينا عند هذه الظاهرة وخاصة فيما يتعلق باللّغة وتبنّينا قاعدة الإعجاز بالصّفة التي تقول "سليم بأن اللّسان العربي استعمل في القرآن الكريم بوجوهٍ من التأليف وطرق في الخطاب يعجز الناطقون عن الإتيان بمثلها عجزاً دائماً"(12) فهذا يؤدي إلى أن يتوقّف المنحنى المنهجي عن الوصول إلى نتائج معيّنة ونقع في النظرة التفاضلية التي هي منهج من يفرض الحقائق على العقول فرضاً، فتستهجن الحقائق في الوقت الذي تستهجن فيه المنهج.
إنّنا نعتبر أنّ اللُّغة ليست مجرّد أداة للتعبير عن الأغراض الخارجية فقط وإنّما هي أساساً "حقيقة حوارية يتواجه فيها عالمان لغويان مختلفان يصيران تدريجياً إلى التداخل فيما بينهما فتنشقّ من هذا لغة متجدّدة تحمل معاني غير مسبوقة، وبهذا يكون الفهم في نهاية المطاف عبارة عن تفاهم"(13). وإذا كان الوجود الحقيقي للغة هو وجود حواري، فهذا يؤكّد المنطق الذي بنيت عليه لغة القرآن من حيث هي لغة وحجّة بالغة بحسب ما ذهب إليه دارسو الإعجاز القرآني، أو ما يمكن أن يندرج ضمن ما تسعى إليه سيميائيات التواصل بدراسة أساليب التواصل أي الوسائل المستعملة قصد التأثير، وهذا يعيدنا إلى الوظيفة الأساسية للُّغات(14). فالخطاب البرهاني أو الحجاجي يهدف إلى التأثير على مواقف وسلوك مخاطبين أو جمهور، وذلك يجعله يتقبّل ملفوظاً معيّناً أو نتيجة معيّنة بالارتكاز على ملفوظ أو ملفوظات أخرى (معطاة، سبب، برهان) والشكل النموذجي القاعدي للبرهنة أو الحجاج يتمثّل في الربط بين المعطيات والنتيجة، كما أن هذا الربط يمكن أن يكون مؤسّساً صراحة أو ضمنياً بواسطة ضامن أو سند، وتكون المعطاة هي الظاهرة والسند هو المضمر في أغلب الأحيان، أما العناصر الأخرى المكوّنة للمقطع الحجاجي فهي تتأرجح بين الظهور والإضمار(15).
وتعود أهمية الحجاج في الدراسات الحديثة إلى العودة القويّة للبلاغة تحت تسمية البلاغة الجديدة، حيث ركّزت على جانبين هما البيان والحجاج كوسيلة أساسية من وسائل الإقناع. ولذلك يمكننا أن نعتبر الخطاب القرآني خطاباً حجاجياً لكونه جاء رداً على خطابات تعتمد عقائد ومناهج فاسدة، وهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين( البقرة 2. فهو يطرح أمراً أساسياً ويتمثّل في عقيدة التّوحيد ويقدّم الحجج بمستويات مختلفة والمدعّمة لهذا الأمر ضدّ ما يعتقده المتلقون من مشركين وملحدين ومنكرين للنبوّة والمعاد ومجادلين. ولعلّ في اختلاف مستويات التّلقّي هذه ما يؤكّد الصفة الحجاجية للقرآن؛ لأنّها خاصيّة أساسية من خصائص الخطاب الإقناعي الذي يعرّفه الدّرس الحديث من الناحية الوظيفية من حيث إنّه موجّه للتّأثير على آراء وسلوك المخاطب، وذلك يجعل أيّ قول مدعّم صالحاً أو مقبولاً بمختلف الوسائل، ومن خلال مختلف الصّيغ اللّغوية إذا اعتبرنا أنّ هذه الصيغ هي أفعال كلام تمارس وظيفة الإقناع من خلال قوّتها الكلامية التي تتجلّى بدورها من خلال طرائق منطقية في البناء والرّبط والعلاقات الاستدلالية التي يمثّل الحجاج أبرز مظاهرها؛ لذلك سوف نركّز في هذه المداخلة ومن خلال النماذج على بلاغة الإقناع المتجلّية في أفعال الكلام ذاتها، ثم نخلص إلى رصد أهم الصور المنطقية وآليات المحاجّة في القرآن ونختمها بنماذج من الحديث النّبوي الشّريف باعتبار أنّ الخطاب النبوي دلائل على الأحكام القرآنية.
1- بلاغة الإقناع من خلال أفعال الكلام:
ليست مهمّتنا هنا رصد مختلف أفعال الكلام actes de paroles من خبر وإنشاء، لأنّ كل كلام قائم على هذا الأمر وخاصّة ذلك المتعلّق بالرسالة الموجّهة إلى مخاطبين معيّنين من أجل بلاغ معتقد أو إبلاغ معرفة أو تبليغ وجهات نظر. ولكنّنا نركز على قوى أفعال الكلام actes illocutoires أي ضروب العبارات التي لها صفة المواضعة وقوتها وقيمتها، كما نتطرّق إلى لوازم أفعال الكلام هذه actes perlocutoires التي تدل على أن ما يحدثه الفاعل طبقاً لقول ما يكون إنفاذه تاماً ووقع الفراغ منه كالحمل على الاعتقاد والوصول إلى الإقناع أو الترك(16).
يتعيّن علينا إذن أن ندرك العلاقة بين القائم بفعل القول وتحقيقه وبين آثاره ونتائجه، ويتجلى هذا خاصة في تلك الحوارات الموجودة في القرآن. وبما أنّ الخطاب القرآني كله يمكن اعتباره حواراً مع مختلف أصناف المخاطبين، فإنّ النتائج والآثار تتجلّى من خلال ردودهم الواقعة أو المفترضة أو من خلال ما ينتج عن أفعال الكلام ذاتها على الرغم من أن أوستين Austin يرى أنّ "نتائج حدوث الفعل ليست من صنف القول ولا من صنف وقوعه على وجه من الوجوه"(17) لأنَّ لازم فعل الكلام يكون مفهوماً من الخارج ومن قرائن الأحوال، ونتيجة لآثارها، فهو إذن بمثابة النتائج المحصّل عليها من متضمّنات القول التي هي في الأصل مترتبة عن تلقي فعل الكلام وليس عن فعل الكلام ذاته بدليل أن ما يفهمه ويتأثر به متلقٍ في سياق قد لا يحدث عند متلق آخر.
هي إذن دواعي الإقناع والنفوذ الخاص بصاحب الكلام وسريان الأثر إذا ما أدى إلى نتائج معيّنة، وسواء تعلق الأمر بالخبر أو الإنشاء فإن قوة أفعال الكلام تكمن في الأثر الذي يتولّد من القول والذي لا يتحقّق بدوره إلاّ بأمرين اثنين هما: بيان وجوب مطابقة الكلام لحال السامعين والمواطن التي يقال فيها، والمعاني المستفادة من الكلام ضمناً بمعونة القرائن(18). وسوف نمثّل أولاً بسورة الرحمن لطابعها الموغل في العقائدية باعتبارها تعالج قضية التوحيد والإيمان وموجّهة إلى فئتي المؤمنين والمنكرين من الإنس والجن، ثم لهيمنة الجمل الإخبارية التي لم تمنعها من أن تكون أنموذجاً للإقناع والحجاج.
يمكن تقسيم سورة الرحمن إلى أربعة أقسام:
القسم الأول من الآية الأولى إلى الآية الثلاثين وهو يتعلّق بذكر عجائب خلقه تعالى.
القسم الثاني من الآية الثلاثين إلى الآية الخامسة والأربعين، وهو يختصّ بذكر النار وأهوالها.
القسم الثالث من الآية الخامسة والأربعين إلى الآية الواحدة والستين ويتعلّق بوصف الجنتين.
القسم الرابع من الآية الواحدة والستين إلى الآية الثامنة والسبعين، وهو يختصّ بوصف ما دونهما من الجنتين.
فالمتمعّن في هذه السورة يلاحظ أنّ العلاقات بين العبارات الإنشائية والعبارات التي تثبت الأحكام مباشرة كالعبارات الخبرية التي يتمحور حولها القسم الأول، وغلبة العبارات الإنشائية في القسم الثاني، أي علاقات منطقية، فتعداد نعَم الله يقتضي الأسلوب الخبري، ثم الانتقال بتوجيه الخطاب إلى المتلقي أي الثقلين (الجنّ والإنس) الذاكرين لهذه النعّم. لذلك هدّدهم بما سيلقونه من عذاب على نكرانهم وجحودهم، فجاء الأسلوب الإنشائي مناسباً لمعاني التوبيخ والتقريع والتعجيز الواردة. أما القسمان الثالث والرابع، فيتراوحان بين الخبر والإنشاء استجابة لمعاني التقرير والوصف من جهة، والتوبيخ والتقريع من جهة أخرى، فيكون الإنشاء تابعاً للخبر الذي يؤكد على الإقرار بوجود نعَم الله لتكون بمثابة الحجة التي تقدم لإقناع المتلقي كلما حصلت فائدة الخبر والتي ترتبط بمن يوجه إليه الكلام حين يكون جاهلاً لحكمه، أو لمضمونه، فيراد من ورائه إعلامه بأشياء يجهلها.
فعندما نتأمل آيات القسم الأول نلاحظ أنّ الجمل الإخبارية كلها وردت خالية من أدوات التوكيد فالله يخبر عباده بالنعَم التي منحهم إياها على سبيل التعديد والتقرير، فجاء الخطاب على أساس أنّ المتلقي خالي الذهن من الحكم، وبعد ذكره هذه النعَم لا ينبغي الإنكار ويسمى هذا الضرب من الخبر ابتدائياً، وهو ينسجم مع منطق التلقي حيث تقتضي إقامة الحجة على المنكر أن يعرف أولاً وهنا يتحقّق قانون الإفادة، الوسيلة المنطقية التي تسبق الأوامر والنواهي أو التوبيخ والتقريع. ومن ثمّ فتعديد النعَم يدخل ضمن الاستدلال بالتعريف، وهو أن يؤخذ من ماهية موضوع القول دليلاً للإقناع. فذكر صفة الرحمانية (الرحمان) ثمّ إحصاء القدرة على خلق الكون بما في ذلك الإنسان؛ لأنّ أصل النعَم يعود إليه. أما قوله (خلق الإنسان من صلصال كالفخار( الآية 14، فيندرج ضمن الاستدلال بالتخصيص بعد التعميم، فكأنّ الله يقول للإنسان: إنّ لم تكن تدري حتى مِمّ خلقت، وقد خلقتك من صلصال كالفخار، ففي العبارة إخبار وإفادة وشمول؛ فإلى جانب إخباره بجهله حقيقة خلقه، زوّده بأكبر قدر ممكن من المعلومات في حدود الإفادة التي تتجلّى في وصف خلق الله تعالى للإنسان.
وفي القسم الثاني من السورة ونتيجة لإنكار بعضهم لتلك النعَم دُعّمت العبارات بالسين التي تفيد التوكيد (سنفرغ لكم أيها الثقلان( الرحمن 31 كما يعكس التعديد ذلك التوكيد أيضاً؛ إذ كلّما ذكرت نعمة من النعَم ازداد الخبر توكيداً؛ وكأنّ التتالي جاء بحسب درجة إنكار المخاطب فيكون زوال الإنكار موازياً لذكر نعَم الله عليه في كل مرة، وذلك من رحمته تعالى؛ لذلك كانت الآية الأولى من "الرحمن" تخالف مقتضى الظاهر الذي يقتضي منطقه أن يقابل الإنكار بالغضب والتهديد. لكنّ رحمة الله وحكمته سبقتا غضبه. كما أنه بدأ بالعام لخلق الإنسان والكون والسماء والأرض وبعد ذلك بدأ يخصّص ويعطي التفاصيل ليقتنع الإنسان أكثر فأكثر وهذا الانتقال من التعميم إلى التخصيص هو كذلك نوع من الاستدلال الذي يمكن تلخيصه في الصورة بما يلي:
أ- بما أنّ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وسخّر له كل هذه النعَم من سماء وأرض وبحر وجزاء من ثواب وعقاب.
ب- وبما أنّ الإنسان لا يستطيع خلق أيّ شيء، فإنّ النتيجة المنطقية لهاتين القضيتين أنّه لا ينبغي للإنسان أن يكذّب، أو ينكر عظمة الخالق وقوّته وجبروته، كما يمكن صياغة عدة استدلالات أخرى تخرج إلى نتيجة مشتركة، فإذا كان لا يمكن التكذيب بالنعَم أو إنكارها ولا بدّ للإنسان أن يؤمن بالله خالق كل شيء، وأنّ الإنسان مآله الفناء، ولا يبقى إلا وجه الله ذي الجلال والإكرام إذن: (تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام( الرحمن 87. ولقد خرجت معاني الخبر إلى أغراض يقتضيها سياق الكلام وجسّدت قوى أفعال الكلام التي لا بد أن تسفر عن نتائج وآثار في نفسية المتلقي. وقد كانت هذه الأغراض منسجمة تماماً مع سريان الأثر في نفسية المتلقي عند تلقي الخطاب، فكل آيات القسم الأول تدلّ على التنبيه إلى قوة الله وسلطانه وجبروته من خلال ذكر عجائب خلقه كقوله (والسماء رفعها ووضع الميزان( الرحمن 7. ومن خلال أمثلة التعظيم كقوله (ولـه الجوار المنشآت في البحر كالأعلام( الرحمن 24. فبعد هذه العظمة لا يبقى للإنسان إلا أن يتأمّل وحدانية الله، فيدرك أنّه مهما بلغ من قوة، فهو عاجز أمام قوة الله وجبروته. والتشبيه الموجود في الآية فيه كما يقول السيوطي من العظم والفوائد و"القدرة على تسخير الأجسام العظام في ألطف ما يكون من الماء وما في ذلك من انتفاع الخلق بحمل الأثقال، وقطعها الأقطار البعيدة في المسافة القريبة، وما لازم ذلك من تسخير الرياح للإنسان، فتضمّن الكلام بناء عظيماً من الفخر وتعداد النعَم"(19). وبعد ذلك برزت أغراض الوعيد والتهديد من خلال ذكر النار وأهوالها والترهيب والتعجيز ثمّ التوبيخ والتقريع في قوله (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) الرحمن 39 أي بعد التكذيب والإنكار لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم، وكأنّ نفي السؤال هو "استخبار محض عن الذنب"(20) ثمّ بعد الزجر جاء الترغيب في الجزاء نحو قوله تعالى (ولمن خاف مقام ربه جنتان( الرحمن 46.
إنّ التدرّج في الأغراض يوحي بالمنطقية في التعامل مع النفس البشرية من أجل إقناعها؛ حيث إنّه لا يجب إعطاء معلومات دفعة واحدة؛ إذا كان المخاطب خالي الذهن، فما بالنا إذا كان الأمر مرتبطاً بهدف تغيير اعتقاد وإزالة الجحود والإنكار، الأمر الذي اقتضى امتزاج الخبر بالإنشاء وخاصة في الآية الاستفهامية المتكررة (فبأي آلاء ربّكما تكذبان( فكانت اللازمة التي تفصل الأغراض الخبرية المذكورة سلفاً، وهي وإن تكررت إحدى وثلاثين مرة فإنّها لم ترتبط بأصل الاستفهام الذي هو "طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل بأداة خاصة"(21) بل إنّ كل واحدة تتعلّق بما قبلها، ولذلك زادت على ثلاثة، ولو كان الجميع عائداً على شيء واحد لما زاد على ثلاثة لأنّ التأكيد لا يزيد عليهما لذا تعدّدت مستلزمات الاستفهام في هذه الآية وذلك لتعدّد مقاماتها وسياقاتها المرتبطة بموضوع الخطاب وطبيعة المخاطبين من منكرين ومؤمنين، بل إنّ المنكرين لم يكونوا على درجة واحدة، فهناك من يؤمن بعد التوبيخ، وهناك من يلزمه بالإضافة إلى ذلك التوبيخ التخويف والتهديد وهكذا. ولذلك ارتبطت آية الاستفهام هذه في القسم الأول بتجديد التوبيخ ثمّ خرجت إلى معنى التخويف والتحذير ممّا سيلقونه يوم القيامة وتأكيد عجزهم من جديد عن عدم قدرتهم على الفرار من عذاب الله، ويظهر ذلك في قوله (يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران( الرحمن 35، لكن على الرغم من هذا الضعف والعجز، فما يزال هناك من يكذب بالله، لذلك خرج الاستفهام بعد ذلك إلى التهديد؛ والتهديد كما يقول الألوسي: "اللطف والتمييز بين المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام من الكفار من عداد الآلاء"(22). أما في آيات القسمين الثالث والرابع والتي تختصّ بوصف الجنتين، فقد خرج الاستفهام في الآية المتكررة إلى معنى التقرير بوجود كل تلك النعَم في الجنتين. فالاستفهام كما هو واضح يلعب دوراً كبيراً في الإقناع وخاصة في العملية الحجاجية نظراً لما يعمله من جلب المتلقي إلى فعل الاستدلال؛ بحيث إنّه يشركه بحكم قوته وخصائصه التي تخدم مقاصد الخطاب، ويلعب دوراً أساسياً في الإقناع بالحجة. وسورة الرحمن نجد حوالي نصفها استفهاماً بلاغياً خرج كله إلى أغراض يقتضيها حال المنكرين وسياق الحديث؛ فكأنّ تكرار الآية ينسجم مع تكرار عملية التكذيب في الواقع، وإذا نظرنا إلى هذا الاستفهام من الناحية الحجاجية، فنجده يخضع إلى الترتيب العكسي، حيث النتيجة- الحجة، وحيث يمكننا صياغة البنية الحجاجية كما يلي:
(فبأي آلاء ربكما تكذبان(- النتيجة.
(الرحمن علّم القرآن
خلق الإنسان
علّمه البيان
الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان
ألا تطغوا في الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان (الحجج) المقدمة
والأرض وضعها للآنام
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
والحبّ ذو العصف والريحان(
ويمكن أن نقرأ ما سبق بما يلي:
لا يمكن التكذيب بأية نعمة من نعَم الله؛ لأنّه الرحمن علّم القرآن.. والحبّ ذو العصف والريحان، ومن ثمّ الاستفهام جاء ليؤدي وظيفة تداولية تتمثّل في إقناع المتلقي من خلال خروجه إلى الأغراض المذكورة. كما أنّه من جهة أخرى وباعتباره فعلاً كلامياً مكرراً ففي ذاته يؤدي هذه الوظيفة الإقناعية "واللافت للانتباه في تعامل المفسرين مع التكرير، أنّهم لم يكتفوا بتتبعه كوسيلة تربط أجزاء الخطاب بعضها ببعض، بل اعتنوا إضافة إلى ذلك بدلالته. فبالإضافة إلى مساهمة هذا التكرير في تماسك الخطاب فإنّه يؤدي وظيفة أخرى هي تأكيد الحجة"(23) لذلك قال الألوسي في سياق تفسيره لهذه السورة بأنّ التكرار "إنّما حسن للتقرير بالنعَم المختلفة والمتعددة، فكلما ذكر الله نعمة أنعم بها وبّخ على التكذيب عليها، كما يقول الرجل لغيره: ألم أحسن إليك بأن خوّلتك في الأموال، ألم أحسن إليك بأن فعلت بك كذا وكذا فيحسن فيه التكرير لاختلاف ما يقرر به"(24).
إنّ تكرار الاستفهام في هذه السورة يبيّن أنّها لم تنزل بعد إنكار واحد أو فعل تكذيب واحد، وإذا كانت أنواع الإنكار متعددة، وأحوال المكذبين مختلفة، فإنّ ذلك يقتضي صياغة خطاب يفهمه البعض في ظاهره، ويؤثر في البعض الآخر من خلال بعض متضمنّاته ويعطي آخرون فرصة تأويله؛ لذلك نجد أنّها أخذت في الاعتبار كل ردود أفعال المخاطبين، ولعلّ في الآية (تبارك اسم ربّك ذي الجلال والإكرام( ما يوحي بأنّ الإقناع بوجود الله، والإقرار بقدرته يقتضي التفكير في نعمه، ففيها "تنزيه وتقديس له تعالى، فيه تقرير لما ذكر في هذه السورة الكريمة من آلائه جلّ شأنه الفائضة على الأنام؛ فتبارك بمعنى تعالى اسمه الجليل الذي من جملته ما صدّرت به السورة من اسم الرحمن المنبئ عن إفاضة الآلاء المفضلة، وارتفع عمّا لا يليق بشأنه من الأمور التي من جملتها، جحود نعمائه وتكذيبها. وإذا كان حال اسمه تعالى بملابسة دلالاته عليه سبحانه كذلك، فما ظنّك بذاته الأقدس الأعلى"(25).
والخلاصة: أنّ دور أفعال الكلام الخبري منها والإنشاء في الإقناع، إنّما يكمن في تلك المستلزمات الخطابية التي تؤول إليها وتحدّد من السياق، وهذا يعني أنّه ليس خطاباً مفروضاً على العقل والوجدان دون أن يترك للمخاطب فرصة التفكّر والاستدلال بالاستقراء والاستنباط. وإنّ الآليات الاستدلالية التي ينطوي عليها الخطاب القرآني هي في جوهرها تقنيات حجاجية، وإنّ في تكرار الاستفهام محاولة لإدارة حوار داخل النفس للاعتراف بقدرة الله، وتكون النتيجة التي تنطوي عليها أفعال الكلام والتي أفاضت الحديث حول قدرته، وتصرّفه في الكون، وارتباط كل شيء به مما يتّصل بالوجود والإنسان، تكون إذن موقفاً تحاكم فيه المنكر ويشعر بضلاله دون أن يحسّ بالمواجهة، بل يشعر بكل ما أثاره الخطاب، وما لم يثره، فيقنع دون إحساس باستلاب الحرية فيما يعتقد بدون ضغط ولا إكراه لا تتجاوب معه النفس؛ وذلك راجع إلى أنّ قانون الشمولية (Loi d’exhausitivité) الذي هو من قوانين الخطاب مهيمن بحكم ما تعطيه العبارة من أخبار وبأقسى ما يمكن "وإنّه من خلال قانون الشمولية هذا ندرك إلى أي درجة يقترب اشتغال الخطاب أو يبتعد من المنطق"(26) وخاصة إذا تعلّق بقانون الإفادة المرتبطة بأقصى ما يمكن من الأخبار التي توجّه إلى المخاطب.
غير أنّ خروج أفعال الكلام للدلالة على معانٍ أخرى هدفها التأثير يمكن أن ننظر إليه على أنه من الآليات الاستراتيجية الإقناعية في القرآن، وهي آليات كما رأينا في سورة الرحمن تقوم على حمل المخاطب على استنتاج معان تدفعه إلى الاقتناع دفعاً. ولقد استعمل القرآن الكريم أساليب مختلفة في مخاطبة المنكرين والمشركين والجاحدين والمنافقين تراوحت بين اللين والشدة والحجة والتضمين، وقد أفاض في أساليب الحوار هذه الشيخ محمد حسين فضل الله في كتابه (الحوار في القرآن) لذلك سنركّز على ظاهرة متضمنات القول التي ربطها العرب ببلاغة الخطاب كما عدّوا التضمين من مباحث علم المعاني، وهي تندرج ضمن الطابع التلميحي للخطاب، وقد ميّز الرماني في كتابه (النكت في إعجاز القرآن) بين وجهين من التضمين: أحدهما ما كان يدلّ عليه الكلام دلالة الإخبار في كلام الناس، والثاني ما يدلّ عليه دلالة القياس في كلام الله عزّ وجلّ خاصة، لأنّه تعالى لا يذهب عنه وجه من وجوه الدلالة. كما يبيّن أنّ كلّ آلية من القرآن الكريم لا تخلو من تضمين لم يُذكر باسم أو صفة، فمن ذلك (بسم الله الرحمن الرحيم( التي تضمن التعليم لاستفتاح الأمور على التبرّك والتّعظيم لله بذكره، وأنّه أدب من آداب الدين وشعار المسلمين، وأنّه إقرار بالعبودية واعتراف بالنعمة التي هي من أجلّ نعَمه"(27).
وسنقف على شكلين أقرّتهما التداولية الحديثة هما: الافتراض المسبق والقول المضمر، باعتبارهما يجسّدان البعد التلميحي للخطاب، وما لهذا البعد من أثر في العملية الحوارية وفي تغيير المعتقدات، وممارسة فعل الاقتناع من دون سلطة ظاهرة. فالافتراض المسبق يتعلّق بالبنى التركيبية؛ أي أنّه يدرك عن طريق فكّ الرموز اللغوية المكوّنة للقول، ويعرفه Ducrot بأنّه العنصر الدلالي الخاص بالقول"(28) وهو يشكّل فعلاً كلامياً خاصاً لأنّه يعتبر شرطاً أساسياً لقيام حوار لاحق في أي زمان أو مكان، وبحسب طبيعة القارئين للخطاب كما هو الشأن مثلاً بالنسبة إلى قرّاء الخطاب القرآني في العصر الحديث، وبهذا يمكن له أن يسهم في تغيير إمكانية الكلام عند المتخاطبين. فالافتراض هو جزء من مرجعية الحوار المرتبطة بمنطقية البناء اللغوي، فإذا أسفر الخطاب عن افتراضات مرفوضة فإنّه سيفقد دوره التأثيري، أمّا إذا استندت إلى نسق من الاستنتاج المنطقي الذي تفرضه التراكيب اللغوية للخطاب، فإنّه يؤدي إلى التواصل والحوار. ومن ذلك في القرآن خطاب موسى عليها السلام في قوله (وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معيَ ردءاً يصدقني إني أخاف أن يكذبون( القصص 34. فيفترض في هذه الآية أنّ موسى قد طلب الفصاحة والبيان من أجل الإقناع، لأنّ القوة المادية لا تصمد أمام جبروت فرعون الذي قال عنه تعالى: (إنّ فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبّح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنّه كان من المفسدين( القصص4.
إنّ طلب الفصاحة يدلّ على قيمة الخطاب في الإقناع؛ لذلك نجد موسى في موضع آخر يقول (واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي( طه 27- 28، ففي تنكير العقدة يُفترض أنّ طلب حلّ بعضها بقدر ما يستطيع أن يفهم عنه فهماً جيّداً ولم يطلب بذلك الفصاحة الكاملة (المعجزة) أما الافتراض الثاني فالعقدة مثلما يذهب إليه الزّمخشري جاءت نكرة كصفة، وكأنّه قال عقدة من عقد لساني(29).
وفي قوله تعالى عن فرعون (قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى( طه 57 فإنّه يُفترض في هذا القول أنّ فرعون كان يرتعد خوفاً ممّا جاء به موسى عليه السلام لعلمه وإيقانه بأنّه على حقّ، وقوله (بسحرك) تعليل وتحيّر وإلا فكيف أنّ ساحراً يقدر أن يخرج ملكاً مثله ويغلبه على ملكه، وهو الذي يملك الأرض والعباد وكل السّحرة(30).
أما قوله تعالى: (وقال فرعون يا أيّها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي اطّلع إلى إله موسى ولأني لأظنّه من الكاذبين( القصص 38 فتُسفر عن عدّة افتراضات مسبقة: الأوّل جهل فرعون بوجود إله غيره لقوله: ما علمت، والثاني أنّ إلهاً غيره معلوم عنده ولكنّه مشكوك فيه لقوله: أظنّه من الكاذبين، والثالث لو لم يكن فرعون المخذول ظاناً ظنّ اليقين، بل عالماً بصحة قول موسى لما تكلّف ذلك البنيان العظيم(31).
هذه أمثلة من الافتراضات المسبقة التي تفرزها البنية اللغوية للخطاب، فتجعل الحوار مؤسساً على ما يقتضيه سياق التراكيب، ومن ثمّ تفهّم مقاصد المخاطب حتى يتمكّن من محاورته بالطريقة التي تفرض التواصل وتأثير صاحب الحجة الأقوى.
أما بالنسبة للقول المضمر الذي يتعلّق بقانوني الشمول والإخبارية فنُمثل له بحوار فرعون مع موسى في قوله (قال من ربكما يا موسى( حيث نلاحظ أنّ فرعون خاطب موسى وهارون في سؤاله: من ربكما؟ ثمّ خصّص موسى بالسؤال، لذلك ترد احتمالات خفيّة لا يفهم قصدها إلا من خلال الإحاطة بسياق القصة. فالاحتمال الأول يدلّ على خبث فرعون في تخصيص موسى بالإجابة دون أخيه لما عرف من فصاحة هارون. أما الاحتمال الثاني فقد ذكره الزّركشي في قوله "إنّه أفرد موسى عليه السلام بالنداء بمعنى التخصيص والتوقّف لأنه هو كان صاحب عظيم الرسالة وكريم الآيات"(32).
أما قولـه تعالى: (اذهبا إلى فرعون إنّه طغى( طه 43 ففيها حثّ لموسى وهارون بأن يذهبا إلى فرعون ويعرضا الرسالة عليه بلين وهدوء لعلّه يستجيب لدعوتهما، مع أنّ الله يعلم بأنّه لن يستجيب، فهناك إضمار بجحود فرعوه في قوله: (لعلّه يتذكّر أو يخشى( لكي يحرص موسى وهارون على دعوة فرعون إلى الإسلام، وتلك من أساليب الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن.
إنّ هذه الأمثلة تدلّ على أنّ الخطاب القرآني فيه من أساليب الحوار ومظاهر التواصل ما يعجز الدرس الحديث عن الإلمام بها، وكلها تجسّد الاستراتيجية الإقناعية والمنهجية المثلى في التحاور بصياغة خطاب لا إكراه فيه ولا انغلاق حتى يتسنّى للطرف الآخر استيعاب الآليات وتفهّم الخطاب، ومن ثمّ تبني الاعتقاد، وهي أساليب كما لاحظنا متّصلة بمعاني أفعال الكلام المباشرة وغير المباشرة لكي يتعلّم المسلمون صياغة خطابات التحاور، وذلك هو الجدال بالتي هي أحسن، فهل هناك أحسن من الكلام يجعل الإنسان يستسيغه ويتقبّله قبل أن يتأثّر بمقاصده؟
2- الإقناع بالحجة: لقد أثار الخطاب القرآني في أساليبه الرسالية أكثر من طريقة من أجل الإقناع والوصول إلى عقل الإنسان وشعوره فيما يفكر في قضايا العقيدة والحياة ليصنع بالفكرة الحق والطريق المستقيم الذي يوصل الإنسان إلى الله دونما إرباك لعقله أو وجدانه. ولقد اعتبر الجدل بالحجة وجهاً من وجوه إعجاز القرآن الكريم باعتباره من بين الأساليب المنطقية الدقيقة في تقرير الحقائق وإيصال الأفكار وتوضيح المسائل العقائدية حيث "اتفق فيه أيضاً استنباط الأدلة التي توافق العقول، وموافقته ما تضمّنه لأحكام العقل على وجه يبهر ذوي العقول"(33)، كما يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي. غير أنّ الأسلوب المنطقي يمتزج في القرآن بالأسلوب العاطفي المثير دون أن يكون ذلك على حساب أدلته وبراهينه، وأما ما جاء فيه موافقاً لبعض الأقيسة المنطقية في المحاجّة فلا يعني أن القرآن يُخضع حججه للقواعد التي اصطلح عليها علماء المنطق لأنّ للقرآن منطقه الخاص، ولا أدلّ على ذلك سوى افتتاح ابن حزم خطابه في كتابه (التقريب لحدّ المنطق) بالصيغة "قال تعالى" وهو في ذلك يخالف المعهود عند نقلة المنطق وشرّاحه الذين يمهدون لكلامهم بالاستشهاد بقول أرسطو عن طريق الصفة "قال أرسطو" وكان غرض ابن حزم هو استخراج تعريف للمنطق من النصّ القرآني ومن الآيات التي أوردها الآيات الأربع الأولى من سورة الرحمن، وجاء بعده الغزالي لينطلق من الآيات التي ستتلوها في نفس السورة(34). ولذلك يعتبر الجدل من الأقيسة المنطقية التي يمكن استنباطها من النص القرآني، والتي سيقت لغرض إعطاء الحجة بغية إقناع المتلقي وحمله على التسليم والإيمان بالفكرة المطروحة بعد دفعه عن فساد قوله وتصحيح كلامه فلا ينبغي عند صاحب العقل السليم ما يجعله يمنعه أو يردّه، وخاصة فيما يتعلّق بالأمور البديهية التي يتّفق حولها سليمو العقول وقد ذكر هذه الأمور الجرجاني في قوله "واعلم أنّ العمدة من هذه المبادئ الأول السبعة هي الأوليات، إذ لا يتوقّف فيها إلا ناقص الغريزة كالبله والصبيان أو مدنس الفطرة بالعقائد المضادة للأوليات كما لبعض الجهّال والعوام، ثمّ القضايا الفطرية القياس ثمّ المشاهدات ثم الوهميات، وأما المجربات والحدسيات والمتواترات فهي وإن كانت حجة للشخص مع نفسه لكنّها ليست حجة على غيره إلا إذا شاركه في الأمور المقتضية لها من التجربة والحدس والتواتر فلا يمكن أن يقنع جاحدها على سبيل المناكرة"(35).
ولذلك كان من أهداف الخطاب القرآني أن ينفذ إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وعندئذٍ تتعيّن الحجة المنطقية والأقيسة التي من بينها الاستدلال بأنواعه وصور القياس المختلفة. فالاستدلال هو عملية التفكير التي يمكن من خلالها استنتاج استدلال معيّن جديد يسمى النتيجة أو المحصّلة استناداً إلى قضية أو عدة قضايا تسمى المقدمات(36). ذلك ما نلاحظه مثلاً في جدال موسى مع فرعون في قوله تعالى (وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين( الأعراف 104 فإذا تأملنا هذه الآية نلاحظ أنّها تضمنت بياناً وتوضيحاً لوظيفة الرسالة وموضوعها، ومحتوى البيان أنّ فرعون ليس رباً ولا إلهاً لأنّ الإله الحق من كان للعالمين بخلقه إياهم وعنايته بهم وفرعون متسلط جبّار يذيق الناس أصناف العذاب والقهر. ومن الواضح أنّ في هذه الآية حجة عقلية قائمة على الاستدلال الذي يأخذ من ماهية موضوع القول دليل الدعوى(37) ويتجلّى ذلك في أخذ موسى عليه السلام من صفة الله (رب العالمين) دليلاً يثبت بأنّه يستحق العبادة، ويمكن تجسيد هذه الصورة كما يلي:
م1: فرعون بحكم واقعه لا يمكن أن يتّصف بكونه إلهاً للعالمين.
م2: وكل من لا يتّصف بحكم واقعه لكونه إلهاً للعالمين فليس إلهاً.
ن: فرعون ليس إلهاً ولا رباً، وادعاؤه الربوبية مجرد افتراء وادعاء باطل.
فالمتأمل لهذا الردّ يلاحظ إضافة إلى كونه تفسيراً لمضمون رب العالمين بعد سؤال فرعون
(قال فرعون وما ربّ العالمين قال ربّ السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين( الشعراء 23- 24 فموسى عليه السلام وجّه نظر فرعون للتأمل بقصد دفع الشك والظنّ لقوله: إن كنتم موقنين.
ويمكننا تبيّن صورة الحجة العقلية هنا فيما يأتي:
م1: الإله هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما.
م2: ولَسْتَ يا فرعون أنت الذي خلق السماوات والأرض.
ن: إذن فلست أنت الإله.
فلمّا أحسّ فرعون بقوة موسى وعجزه أمام حجته لجأ إلى منطق القوة، وعزم على قتل موسى حتى تدخّل من يمتلك الحجة العظمى فقال (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يَعِدُكم( غافر28 والحجة العظمى هذه كما يسميها محمود يعقوبي هي حجة محرجة لأنّها تجبر الخصم على النظر إلى الأمر من وجهين، وأيَّاً كان الوجه المختار، فإنّه تلزم منه نفس النتيجة، وتسمّى هذه الحجة عند المنطقيين قياس الإحراج، وصورته هي:
- إما أن يكون موسى كاذباً، وإما أن يكون صادقاً فيما ينذركم به.
- فإن يكن كاذباً فعليه كذبه، ولا يضركم كذبه.
أ- فلا ينبغي قتله.
- وإن يكن صادقاً، يصبكم بعض الذي يعدكم، ويكون بهذا قد نصحكم.
ب- فلا ينبغي قتله(38).
ظهرت إذن مواجهة فرعون لموسى في قوله (وما رب العالمين) ولا يخلو هذا السؤال من جهل بكل شيء، فهو يعتقد أن الأمر لا يعدو أن يكون متعلقاً بشخص منافس له غير معروف(39) بدليل أنّه استعمل في سؤاله حرف (ما) الذي يستعمل عادة للدلالة على السؤال عن شيء مفرد وأعمّ ما يقرن به كقولنا: ما الشيء؟ أو ما معنى الشيء؟ كما أنّ (ما) يُلتمس به الشيء أو ماهيته من حيث إنّ أجزاء ماهيته قائمة في طبائعه"(40) وبما أنّ ربّ العالمين لا ماهية له، لأنّه الأول والآخر والباطن والظاهر ردّ موسى بقوله (ربّنا الذي أعطى كل شيء ثمّ هدى( طه 50 أي كما ذهب في تفسيره سيد قطب "ربّنا الذي وهب الوجود كل موجود في الصورة التي أوجده بها، وفطره عليها ثمّ هدى كل شيء إلى وظيفته التي خلقه لها.. وهذا الوصف الذي يحكيه القرآن عن موسى يلخّص ويعمم أكمل آثار الألوهية الخالقة المدبرة لهذا الوجود"(41).
ويمكن تلخيص الاستدلال الأول العام فيما يلي:
م1: الله قد أعطى كل شيء خلقه الملائم.
م2: كل من كان ذلك شأنه فهو ربّ العالمين.
ن: إذن الله ربّ العالمين باعتبار أنّ سواه لم يتصف بما اتّصف به هو بحكم الواقع.
وهذا يعني أنّ الحوار لا يكون مفيداً إلا إذا توفرت أدلة إثباته، وكما يجب أن يقدم نتائج مفيدة تظهر على المتحاورين، لعلّ أهمّها ما يسفر عنه من تأمل عند ردّ الفعل يردفه قبولاً أو نقلاً مبرراً بالحجة كذلك. أما إذا كان الفعل الكلامي غير نافذ لتعصب الطرف الآخر كما هو الأمر عند فرعون مثلاً، فإنّه في هذه الحالة يلجأ إلى الجدال دون استعمال الوسائل اللفظية كالإشارة أو أي فعل مثل عصا موسى أمام فرعون والسحرة، وفي هذه الحالة فإنّ لازم فعل الكلام يحسن خارج العبارة لأنّه كما يقول أوستين "يجوز إيقاع التهديد أو التخويف بتحريك العصا أو تصويب البندقية وحتى في الحالات التي يمكن فيها أن نحثّ الآخر أو نقنعه أو نجعله يطيع أو يعتقد في أمر وما، فنحن نستطيع أن نصل إلى غرضنا بدون عبارة ما أو بدون فعل كلامي"(42) وهذا يدلنا على أنّ الكلام ليس وحده وسيلة الإقناع، بل نستطيع أن نحتجّ أو نتحاور بدون استعمال الألفاظ، ومع ذلك فإنّه يدخل تحت قوى أفعال الكلام لأنّها المعادل الموضوعي له، لذلك جاء في الحديث الشريف: [الدين المعاملة].
لسنا في هذه المداخلة بصدد عرض مفصّل للصور المنطقية كلها في القرآن، لأنّ هذا يستدعي جهداً أكبر سبقني إليه البعض مثل محمد التومي
